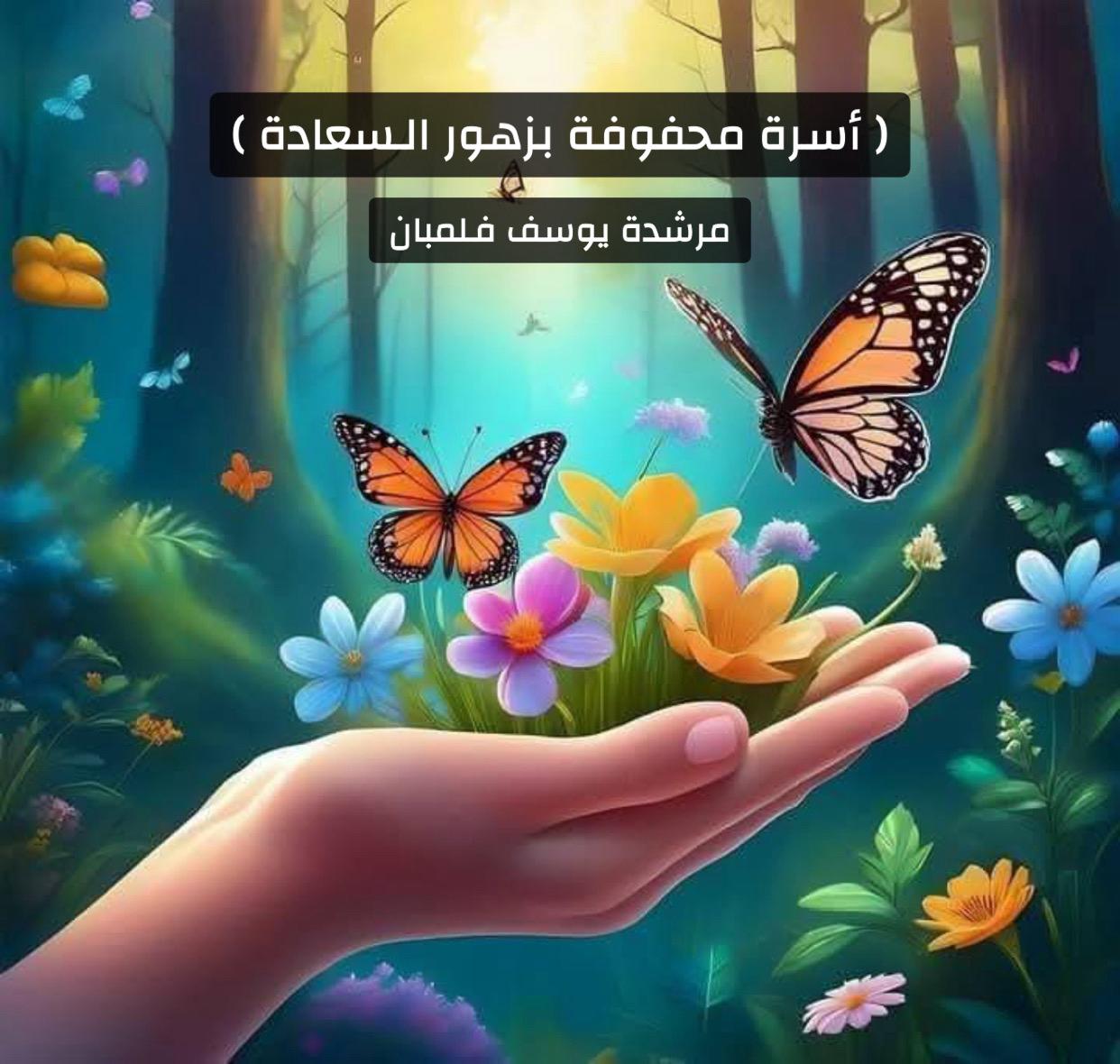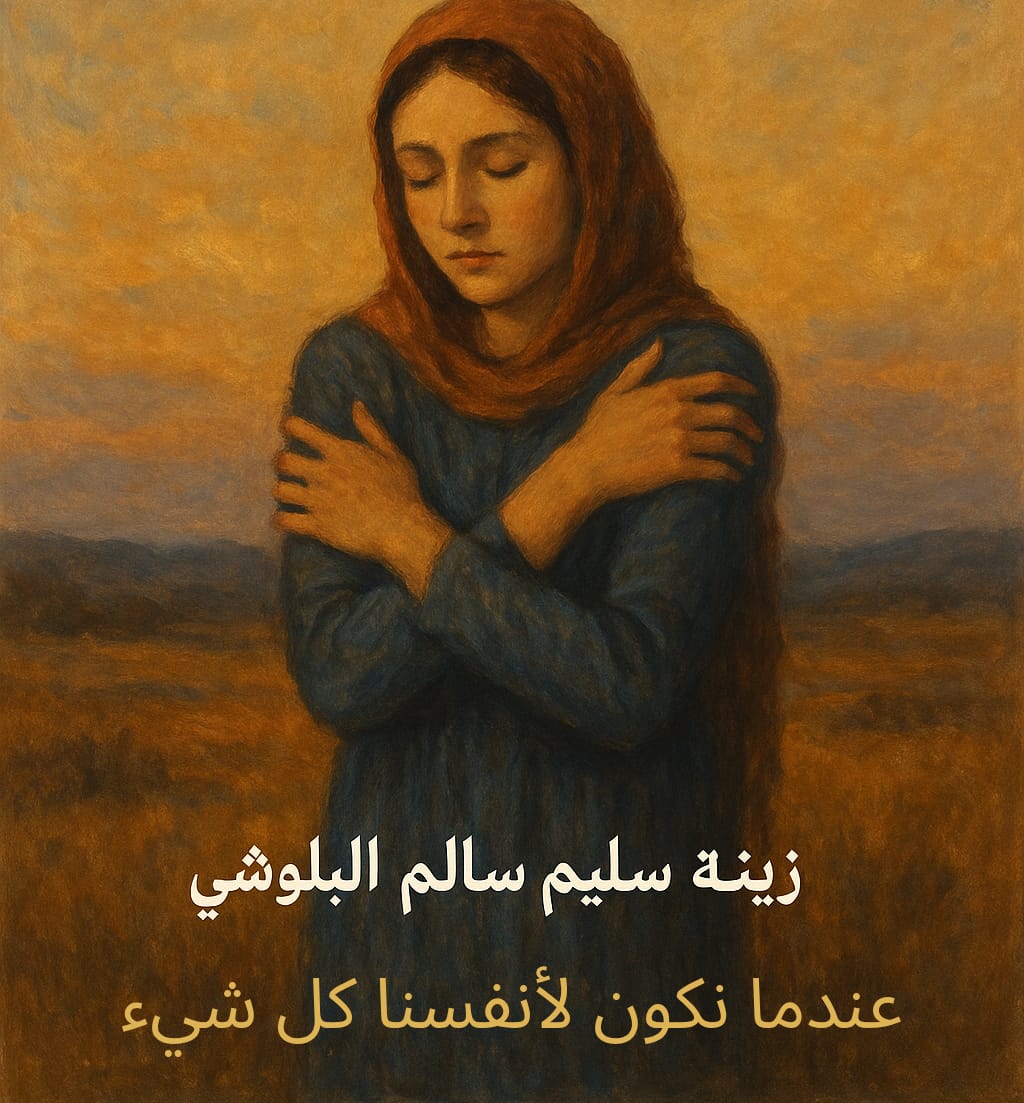لَيلى عَلوي وجباحُ العزعزي، الأستعارة في الثقافة الشعبية


مجيب الرحمن الوصابي
في أحدِ شوارعِ حيّ الشيخِ عثمانَ بعدنَ سمِعتُ شخصًا يقولُ لصديقه بإنبهار: ” أنظر ليلى عَلوي ” مشيراً إلى إحدى السيارات الفارهةِ آنذاك، كان هذا منذُ زمنٍ، وأستعيد الآن هذه القصة وأنا أتساءلُ عن الإستعارة والرمزيّة التي أُغرمتُ بها في مرحلة الدراسات العليا لماذا يطلقُ اليمانيون هذه الكلمة على سيارة خاصة؟
 هلِ الإنسانُ صاحبُ هذهِ الإستعارةِ التي صنعها بعفويةٍ وابتدعها بلاشعور على صورةِ حُلم قد شكّلت له حلما آنذاك ؟.. ربما! لكن المؤكد أنّه كان مبدعاً!
هلِ الإنسانُ صاحبُ هذهِ الإستعارةِ التي صنعها بعفويةٍ وابتدعها بلاشعور على صورةِ حُلم قد شكّلت له حلما آنذاك ؟.. ربما! لكن المؤكد أنّه كان مبدعاً!
حقيقةً نحن لا نكاد نقول جملةً أو نسمعها إلا واستخدمنا “الإستعارة” والكلُّ يفهمُها دون دروس بلاغية، أو تفكيك أو تحميل دلالات وتأويلات، وكلُّ كلامِنا إستعارات؛ وفي ” الإستعارة” شيء من الغيبيات! ( الجنوب قادم )
بل إنّ للأستعارة حضورٌ يتعدّى الوظيفةَ البلاغيةَ إلى الوظيفة السحرية التأثيرية الضارة كما يُعْتَقدُ فيما يُعرفُ شعبياً بالـمَـرَّاعين “المتلفِّظين” للأستعارة؛ أي الذين يمارسون تأثيراً بالنظر بأعينهم مع التلفظ بــ”ألسنتهم” بجملٍ تشبيهية؛ لذا عُرٍفَ المرَّاعون بعلاماتٍ في ألسنتهم من ندوب أو سواد و …. وعلينا أن نميِّز بين العين والحسد؛ والعين الذي يصحبها تلفظ مفهوم، أو العين الصامتة ولا مجال للخوض في هذه الفروقات.
ما يعنينا هنا العين التي يصحبها تلفظٌ؛ عادة تكون جُملاً استعارية يتلفظ بها أصحابها تقوم على إيجاد المشابهة بين شيئين بسرعة بديهة وذكاء.
و”المرّاعون” جمع “مرّاع” وهي لفظةٌ مقتصرةٌ على جنوب الجزيرة العربية في الدلالة؛ لأنَّ القواميسَ العربية لا تعطي لها هذه الدلالة؛ و لن نتعسَّف إيجاد بعض المقاربات وأشهر من ارتبط بهذه الصفة “عبدالرحمن جُباح العزعزي”.
يقولُ جباح العزعزي في إحدى اللقاءات التلفزيونية إنَّ ما يقوم به ليس سوى إيجاد التشبيهات بين الأشياء المنظورة وأشياء أخرى بسرعة بديهة وإيجاد التماثلات، ربّما رَكِبَ “جُباح” موجة الظرافة واستثمرها، ونُسبت له كثير من الأستعارات التصوّرية في حكايات ، لكن ما يهمنا أن العزعزي” جباح” كان مبدعاً بل شاعرا، ألم تربط الذاكرة التراثية الشعبية بين الشعر والسحر، وجُباح مؤثـِّر بلسانه وأستعاراته وتشبيهاته، من أشهر الأمثلة الاستعارية الجُباحية هذه المرويات:
كان يجلس في البيت ولديه دجاجة وحولها فراخها؛ هبطت عليهم حُدَيّة (حدأة) لتأخذ الدجاجة وتطير؛ لتراها الزوجة وتصيح (الحدية) أخذت الدجاجة ؛ ليرد بحسم وبديهة العزعزي جباح ” موجهاً ببصره نحو الحدية والدجاجة :
(( ماذا تعمل بها – يقصد الدجاجة – أخذت الثلاجة وأبقت القلاصات)) …فلم تمض سوى دقيقتين إلا والحدية والدجاجة في الأرض
مُشبِّهاً بإستعارة تصورية الدجاجة وفراخها ( بالدّلة والفناجين )
وهذا هو المزج التصوري عند هذا الشخص بين الشيء الحاضر ” مشهد الدجاجة مع فراخها” والغائب الصورة ” الدلة والفناجين” التي تماثله التلفظ السريع من ” العاين” ” المرَّاع جُباح”.
ومن المؤكَّد في العرف اللساني البلاغي أن صاحب هذه الاستعارة مبدع ويقول الشعر بالمفهوم الواسع.
في الخطاب اليومي وكلامنا العادي كثير من الأستعارات، وحتى في لعبة ( المُناجمة*) بين الأطفال وهي لعبة تلفظيّة تزدهرُ في الأحياء الشعبيّة فيها من (الأستعارات) ما يذهلُ بغض النظر عن أخلاقياتها، بل يمكن للمراقب أن يتنبأ بأصحاب الملكات الإبداعية من بين المتبارين الصِّغار أصحاب الخيال الخلّاق.
حدثني أكثر من شاعر وأديب بأنه كان متفوِّقاً في هذه اللعبة في طفولته! وهكذا يربط أرسطو بين الاستعارة والعبقريّة والإبداع
مما أتذكَّره من هذه الاستعارات التي كانت (مناجمة) من السخرية في الأغلب
: رأسك كما قبة المسجد ، ” أسنانك طبق بيض” ” عيونك فتاتير” وغيرها
إذن الأستعارة ليست وقفاً على المبدعين: أدباء وشعراء وفنّانين أو “مَـرَّاعين” بل ” هي آلة عرفانية تحكم تفكير البدائي كما المعاصر، البدوي كما الحضري، والطفل كما الشيخ، إنها مرتبطة بهويتنا نحن البشر؛ فهي التفكير عينه في جزء كبير منه؛ لذلك فهي مُندسَّة في كل تفاصيل حياتنا في كلامنا العفوي كما في أكثر نظرياتنا تجريداً، في كلام العامة كما في كلام الأدباء والسَّاسة ورجال الدين والرياضيين والمُنظِّرين، إنها ما به نفكِّر وما به نحيا كما عبّر عن ذلك لايكوف وجونسون.
أكاديمي وباحث يمني مقيم في تونس